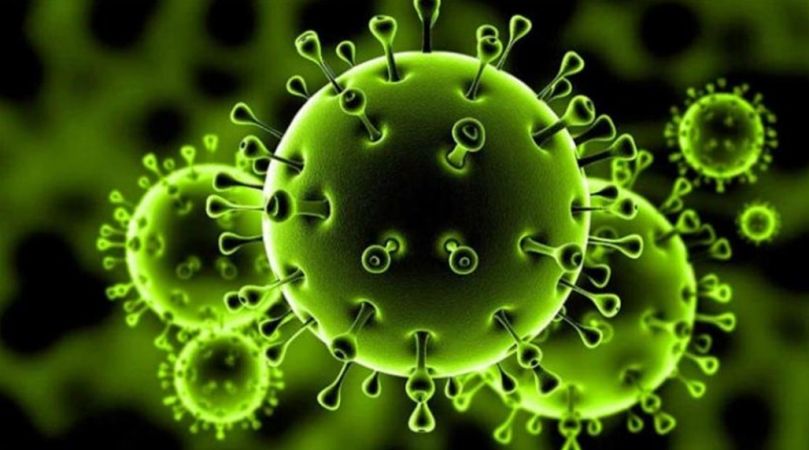أثار تلميحُ إيغور نيكولين، العضو السابق في لجنة الأسلحة البيولوجية والكيماوية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن ظهور فيروس كورونا في الصين قد يكون سببه سلاح بيولوجي أمريكي ضجةً إعلاميةً كبيرةً واستدعى ردوداً رسمية وحملةً إعلاميةً أمريكيةً واسعةً للرد عليه، بل وللتهجم عليه ووصم كل من يوافق هذا الرأي بتأييد "نظرية المؤامرة"، إلى الحد الذي يطابق المثل العربي الشائع "كاد المريب أن يقول خذوني"، رغم أن الصحافة الغربية عمدت منذ الأسابيع الأولى لإنتشار الفيروس الغامض إلى رمي السلطات الصينية بسلسلة من الإشاعات غير المدعمةً بوثائق تبدأ باتهامها بإخفاء العدد الفعلي لضحايا الفيروس ولا تنتهي باتهامها بالوقوف خلف الفيروس وأنه انطلق من أحد مختبراتها في "ووهان".
أعادت مواقع صينيةُ وعالميةُ التذكيرَ بالقضيةِ التي أثيرت عام 2000 حول فريقٍ بحثي أمريكي، تابع لجامعة هارفرد، افتُضحَ أمرُ قيامه بجمع عينات من مواطنين صينين حصراً عام 1997 عبر إيهامهم بأنهم يشاركون في أبحاث تعزز مستواهم الصحي، كما أُعيد نشر تصريح الملياردير الأمريكي الشهير جورج سوروس خلال منتدى دافوس في كانون الثاني الماضي الذي اعتبر فيه أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ هو أخطر عدو على مجتمعات العالم الحر" موصياً بشن هجمات ضد الشركات الصينية، قبيل أسابيع فقط من انتشار الكورونا، للتدليل على أن ثمّة شكوكاً بتورطٍ بشريٍّ في هذا الانتشار، خصوصاً أن فيروس السارس تركّزَ عام 2003 في جنوب الصين وشرق آسيا مستغلاً وجود موروثة HLB46 لدى السكان التي تتعلق بقابلية العرق الأصفر لالتقاطه بسهولة.!
ومهما يكن من أمر فإن تبني أيٍّ من الاتهامين لا يُغيب حقيقة عودة خطر الأسلحة البيولوجية إلى واجهة البحث بل وتركيز البحث على فكرة الإبادة الانتقائية التي لم تعد خيالاً علمياً على صفحات رواية روبرت هيلين الشهيرة "العمود السادس" (1942) التي يرد فيها استخدام "سلاح إشعاعيٍ مخصصٍ حصراً لاستهداف الغزاة الآسيويين الذين أسقطوا الأمم الحرة واحدةً تلو الأخرى"، ولا سراً خلف الجدران المغلقة، بل مثار جدلٍ حقيقيٍ على صفحات الكتب العلمية والدوريات المتخصصة التي تؤكدُ أن سعي الإنسان منذ القدم للاستحواذ على سلاحٍ نوعيٍ يمنحه تفوقاً عسكرياً في حروبه بحيث يكسب أي حربٍ بأقل خسائر ممكنة في صفوفه مقابلَ أكبر الخسائر في صفوف العدو، لم يتحقق باختراع السلاح الذري الذي شكل كابوساً مرعباً للبشرية منذ منتصف القرن الماضي، بل هو سلاح أكثر رعباً وفتكاً من السلاح النووي، ويحقق الشرط المطلوب تماماً بحيث يسمح لأي أمةٍ باستهدافِ أمةٍ أخرى بشكل انتقائي دون أدنى مخاطرة بمواطنيها وهذا ما يسمى بالسلاح البيولوجي العرقي Ethnic Bioweapons. وقد ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية -مثلاً- أن الجمعية الطبية البريطانية BMA درست عام 2004 إمكانية استخدام القنبلة الجينية، وهو ما اعتبرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر "أمراً غير بعيد المنال"، بل وقد سبق ذلك تحذيران شهيران، الأول عام 1997 حين صرّح وزير الدفاع الأمريكي وليام كوهين بأن بلاده تمتلك قائمةً بدول تسعى لصنع أسلحة عرقية تستهدف شعباً بعينه، وأن هذا خطر محتمل، أما الثاني فهو تصريح الرئيس السابق لحلف شمال الأطلسي NATO الأدميرال جايمس ستافريديس لمجلة فورن بوليسي عام 2006 بأن الأسلحة البيولوجية يمكن أن تقضي على خمس سكان الكوكب، وكان مركز أبحاث القرن الأمريكي الجديد PNAC قد أعد ورقةً بحثيةً عام 2000 تحت عنوان "إعادة بناء دفاعات أمريكا" تتضمن إمكانية الاستفادة سياسياً من القنبلة الجينية.
أما المنطقة العربية فترزح تحت خطرٍ أكبر إذ تجاورها "إسرائيل" التي اهتمت مبكراً بالأسلحة البيولوجية وأنشأت وحدةً متخصصةً في هذا المجال بتوجيه مباشر من الرئيس المؤسس ديفيد بن غوريون أسميت "همد بيت"، وبعد بروز فكرة التلاعب الوراثي بالجراثيم والميكروبات لأهداف عسكرية وبناء على رغبة القادة الصهاينة في امتلاك سلاحٍ يوجه ضد العرب حصراً، تعاونت هذه الوحدة التي صارت تدعى "مركز إسرائيل للبحوث البيولوجية" IIBR من خبرات نظام الفصل العنصري في أفريقيا الجنوبية الذي اعترف رئيس مركز أبحاث الحرب البيولوجية فيه بأنه كان يُطور سلاحاً بيولوجياً يستهدف الصبغة السوداء في جلد الأفارقة، وقد أجرت عدة تجارب على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وخصوصاً على الأسرى العرب في المعتقلات، ويعتقد أنها أجرت تجربةً واحدة على الأقل خارج فلسطين عام 2012 في قطر، بعد تحصيل فتاوى حاخامية، لكن صدى تلك الجهود بقي خافتاً في الإعلام العربي والعالمي باستثناء تصريح عبد الوهاب الدراوشة، زعيم الحزب الديمقراطي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي، الذي كشف لصحيفة البيان في عدد 19 تشرين الثاني 1998 عن الجهود الإسرائيلية الحثيثة لتصنيع قنبلة بيولوجية عرقية في معهد "نيس تزيونا" جنوب تل أبيب، وتقرير صحيفة "سانداي تايمز" الذي نشرته قبل أيام من مقالة "البيان" في الخامس عشر من الشهر نفسه الذي يتناول تصنيع "إسرائيل"، بمشاركة بريطانية، لقنبلة عرقية تستهدف تسلسلاً معيناً من الحمض النووي الخاص بالعرب، بعد دراسة واسعة للسمات الوراثية العربية، لكن المشروع ما يزال يصطدم بعقبة هامة تتمثل في إشتراك العرب واليهود المزراحيين (لا سيما اليمنيين والعراقيين) بموروثات جينية متشابهة.
يبدو أن إمكانية تصنيع سلاح بيولوجي عرقي دقيق بنسبة 100% غير متحققةٍ حالياً بسبب اختلاط الأعراق جغرافياً الناتج عن موجات الهجرات الكبرى وبسبب وجود مجموعات عرقية "صغرى" تشترك في جيناتها مع بعض المجموعات الكبرى، كما أن هناك احتمالاً قائماً بحدوث طفرةٍ جينية غير مقصودة في الفيروس تحوّر وجهته بخلاف المسار المرسوم له، أضف إلى ذلك السعي العالمي الحثيث لتجريم كل ما يتعلق بالأسلحة الجرثومية دولياً لكن التزام دول العالم بالمعايير والضوابط الأخلاقية والقانونية في التجارب العلمية البيولوجية ليس مدعاة ثقة، رغم توقيع معظمها على بروتوكول جنيف 1925 الذي يحظر استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية ومعاهدة 21 نيسان 1972 التي تمنع تخزين وتطوير تلك المواد، والأمثلةُ على ذلك كثيرة، حيث تم إغلاق مختبر حيوي عسكري أمريكي عام 2000 في أندونيسيا لإجرائه تجارب سريرية على فيروس إنفلونزا الطيور المصنف وباء عالمياً، وعام 1997 اعترفت الباحثة الأمريكية جانيس برافو بمساعدتها لشركات التبغ في رفع أرباحها عبر تهجين شتلات التبغ لتحوي نسباً أعلى من النيكوتين وبالتالي ترفع نسبة الإدمان دون أي اعتبار للعواقب الصحية، ناهيك عن عشرات التجارب المخيفة كالتي اكتشفت في ملجأ للأطفال المتخلفين عقلياً بنيويورك عام 1956 كان يتم حقن نُزلائه بفيروس التهاب الكبر الوبائي لإجراء دراسات على لقاحات الأطفال لصالح شركة أدوية لا تقيم أي وزنٍ للحياة البشرية مثلها في ذلك مثل الكثير من الشركات التي حذرت منظمة الصحة العالمية مراراً من قيامها بطرح أدوية في أسواق العالم الثالث لا تحتوي مواد فعالة أو تحتوي نسبةً قليلةً منها بهدف مضاعفة الأرباح !.
فهل يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي منتظراً ببلاهة وصول هذه البرامج إلى خواتيمها ومواجهة هذا الخيار كحقيقة مرعبة؟
المقالات الواردة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع